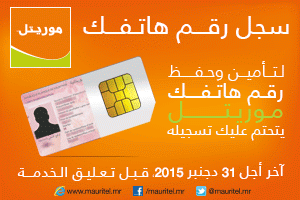السفر ثقافة، يهبك مالا يهبك كتاب أو حتى مكتبة، لأنه تماس حقيقي ومباشر مع الحياة ومع الجمال ومع الآخر بكل وعيه أو لا وعيه. السفر وعي كبير يتسرب عميقا حتى يستحوذ على كل وجدانك. تلك المقارنات لصالح الآخر أو ضده هي صناعة لوعي الإنسان العميق والمختلف والجارح والناقد. تلك الاختلافات الضمنية التي تدهش الروح في الأمكنة والبشر والحياة والفنون تجعل الإنسان ممتلئا ومدركا لبعض الحقيقة.
السفر الذي يعلمك دروسه بخفة بلا تلقين ولا إجبار، فلا يثقل على روحك وكاهلك بمعارف ولا بمعلومات. يكفي أن تحمل نفسا تواقة للجديد، محبة للغير، منفتحة على المغايرة والاختلاف. يكفي أن تفتح قلبك وروحك للكون وأجنحتك للتحليق، ووعيك للجمال وللآخر، يكفي أن تأتي للمكان بحثا عن الراحة والاسترخاء ليفتح لك هو قلبه ويديه، ويعلمك أكثر مما تطمح له، أو تحلم به.
لا يهم أين يسافر الإنسان، المهم أن يكسر الرتابة وتلك الأفكار الجاهزة عن عدم جدوى السفر، ويمتطي عزمه ليخوض مغامرة جديدة، يربي حسه الجمالي، وإحساسه النقدي، ويفتح حواسه على الحياة والوجود، ليتعلّم من كل شيء، من الطبيعة بجمالها المتنوع بين البيئات العذبة والمالحة (الأنهار والبحار، والغابات والشواطئ)، ومن المدن بمبانيها وطرزها العمرانية التاريخية الحضارية أو الجديدة العصرية، ومن الإنسان بثقافته المغايرة في الملبس والمأكل والمشرب والحياة، ومن الفن بكل أنواعه وأشكاله القديمة والجديدة، ليرى أنه جزء صغير وصغير جدا من هذا الكون الفسيح، وأن عليه أن يتأمل فيه، وأن يستشعر جماله وجمال صانعه، فتتسع روحه ويسمو وجدانه، ويستشعر عظمة الخالق وعظمة الوجود معا، فتهدأ نفسه، وتنمو ثقافة الحب والسلام محل ثقافة القلق والخوف والكراهية والتنافس المريض، والقتل بمسمياته المتعددة.
والسفر يكشف طبيعة الإنسان ووعيه وثقافته واهتمامه، فهناك من يذهب بحثا عن جمال الطبيعة فيرتاد الأماكن الطبيعية، وهناك من يذهب للتسوق، فيبحث عن كبريات المتاجر والمحلات، أما المثقف فلا يمكنه أن يكتفي بالسطحي من المدن، والخارجي من البلاد، والقليل من المكان، بل يسعى لاهثا خلف العميق من الجمال ومن التاريخ فتجده يبحث عن المتاحف والمسارح والآثار الخالدة، وعن معارض الفنون، وحفلات الموسيقى، وعن الجمال الخالد الذي يخلفه الإنسان المختلف الذي يعبر هذا الوجود بخفة، فيترك آثاره دلالة عظيمة على عبوره الراسخ فيتعالق معه، ويتحد فيه.
المثقف المشغول بهواجسه وأفكاره عن الفن والوجود والإنسان، والذي يحمل وعيه ومشاريعه حتى في الإجازات والسفر، بل لعله يدخر الكثير من تلك المشاريع للإجازات تحديدا، فيجعل السفر ضمن مشروع ثقافي ما، أو سياحة ثقافية مخطط لها. وهي حالة مشروعة وهامة لمشروعه الإنساني والثقافي الطويل والممتد من نقطة الصفر حتى نقطة الصفر، ويظل في سفره أسير الفتنة الخارجية والداخلية معا، فكل ما يراه يتخلّق فكرةً في وعيه أو لا وعيه، ويعزز مشروعاته التي لا تنتهي، ولا يريد لها أن تنتهي، ومشاغله الوافرة والمتناسلة من رحم الوقت والمكان، والتي قد يحمل الكثير منها في حله وترحاله، كقراءة رواية لصديق يريد رأيا، أو قراءة كتاب لصالح فعالية، أو ورقة علمية، أو يراجع جزءا من رسالة علمية، أو يكتب فصلا في رواية أو كتاب أو قصيدة من المكان، أو كل هذا معا، إضافة إلى كتابة طارئة تشغل رأسه فيسفحها على صفحات جهاز رقمي أصبح الدفتر والكتاب معا، فيجعل افتتانه بالمكان متصلا بداخله وخارجه.
المثقف الذي لا يستطيع أن يتجرد من ذاته، أو يتبرأ من وعيه في السفر، بل لعل ذلك الوعي يتأجج ويتوهج في تلك المقارنات الكثيرة والموجعة بين بلاده و»بلاد الكفار» كما يسميها المتأدلجون، الذين يعيشون في خرائب عقولهم، وأمراض قلوبهم، وانغلاقات وعيهم، سادين الطرق نحو كل جمال ووعي. وفي أبسط مقارنة عادلة نجد أن لدى «بلاد الكفار»، التي ما فتئوا بجهلهم وحقدهم يحملون إليها الموت والدمار، كل أسباب الحياة للإنسان، من المحبة والسلام حتى أسباب الحياة الكريمة، من طرق سهلة، ومواصلات عامة في غاية الدقة والاتقان، ومن الملامح الثقافية كالمكتبات التي تنتشر كزهور الطرقات في كل مكان أو كالخبز والجياع كثر، حتى المقاهي والأرصفة، والمدارس التي تخرج أجيالا حرة وواعية وعميقة المعرفة، والمستشفيات التي نلجأ إليها مضحين بالغالي والنفيس بحثا عن الشفاء إذا أعيتنا الحيلة في مستشفياتنا التي وكأنها مخصصة لزهق الأرواح، وقتل الأمل، في بلداننا التي تتكلم باسم الإسلام وهو منها بريء. حتى الجامعات التي يهاجر إليها أبناؤنا مفاخرين بدراساتهم في أقوى الجامعات الغربية، وأكثرها علمية ومصداقية، فالبحث العلمي الذي يهبنا كل يوم اختراعا يخفف علينا عبء الحياة، أو يداوينا من مرض عضال، أو يحمينا من كارثة كونية، وليس نهاية بالحرية والأمان، والكرامة ولقمة العيش، حيث لا يموت أحد جوعا، فيكفي أن يحمل موهبته كريشته أو آلته الموسيقية أو أي موهبة يملكها، ويقف على ناصية ما ليحصل على قوت يومه. يكفي أن تكون لديه «دراجة هوائية» ليحوّلها لوسيلة لنقل السياح، بلا تراخيص، أو تعميمات أو حجر على الأرواح والعقول، ناهيك عن الفرح والجمال والأمل، فكل شيء يمكن أن يمتع الإنسان البسيط والطيب والمتشبث بالحياة حتى آخر رمق.
«بلاد الكفار» التي تعمل لصالح الإنسان في كل خططها ومشاريعها بلا تضييق ولا احتكارات لصالح شخوص أو مؤسسات أو فئات أو نفوذ أو سلطات، بل الإنسان أولا وأخيرا، فيستشعر هو دوره في الحياة، فيتعلم ويعمل، لصالح نفسه وبلده.
البلدان التي تدرك جيدا أن السياحة اليوم هي أهم مصادر التدخل، فتسعى لتطويرها وإشراك الإنسان ابن المكان في تفاصيلها الدقيقة من الأكل حتى الفنون، فيتفنن في جذب السياح. السياحة التي تتخذ أشكالا أكثر عصرية وجمالا من السياحة المكانية والترفيهية فقط، فهناك السياحة المعرفية أو العلمية وهناك السياحة الطبية، وهناك السياحة الثقافية والفنية التي تغزو العالم اليوم بالجمال والفن والموسيقى والبهجة الاحترافية. تشتعل الأوبرا في الصيف، وتتحفز الفرق الموسيقية، وتبتهج دور العرض والمسارح، وتتجلى المتاحف الفنية بكل أنواعها الجديدة والتاريخية لتخبر العالم عن تاريخ الإنسان وفنه، وعن المكان وحضارته. بل وتصبح الأرصفة معارض فنون وإتيليهات، وتتوزع الفرق البسيطة والفردية في كل مكان لتشكل ظاهرة ثقافية وحضارية وإنسانية، ويصبح المكان متحدا بإنسانه، مبتهجا بالزائر الجديد، راغبا في تعريفه على أكثر ما يمكنه من المكان تاريخا وحاضرا وثقافة.
تمخر المراكب والعابرات بين المدن، وتعلو صافرات القطارات برحلاتها اليومية لتضم وجوها غريبة لا يسألها أحد من أنت؟ ولا من أين جئت؟ إنها تأتي وحسب، تأتي محملة بضجر عام طويل من العمل والجهد، وحر صيف جهنمي لا يحتمله الحديد فكيف بالجسد الآدمي. تأتي من ثقافة ليس لديها ثقافة السفر، فتكسر كل تلك القيود، وتتسامى في الحالة الإنسانية والثقافية والمعرفية، وتتماهى في روح المكان الجديد حبا وفرحا، وتنسجم مع كائناته نبلا وإنسانية، وتتبتل في المتاحف والمعارض الفنية، وتتماهى مع الموسيقى، وتتصاعد بخفة مع جمال الطبيعة، وتشرئب مع المطر، وتذرع الأرصفة لتتعلم لغة التماس مع الوجود والأرض والحياة، خارج العلب التي جاءت منها، وخارج ثقافة العيب والحرام والموت التي تصر على إثبات دمويتها يوما بعد يوما.
وتتعلم الحرية كأهم دروس السفر، الحرية التي تقرأ عنها وتسمع عنها، ولكنك تلمسها في السفر لمس اليد، الحرية التي تعلمك الاختلاف، وتقبّل الآخر، وتقبّل نفسك كما هي، فلست مسؤولا عن أحد، ولا أحد وصي عليك، الجميع راشد بما فيه الكفاية، الجميع مشغول بنفسه، بداخله، بمشاريعه، بأفكاره بجسده، مشغول لدرجة أنه لا يراك، وفي هذه اللارؤية تكمن الحرية الحقيقية، فلا أحد يراقبك، ولا أحد يؤوّل تفكيرك، ولا أحد متأهب لتنميط وعيك، ووضعك في خانات (رجل، امرأة، متدين، ملحد). لا أحد يهتم باعتقادك، أو بعقيدتك، بجسدك، بلبسك، بطعامك، بشرابك، بكل ما تملك أو لا تملك. فأنت حر وهو حر، مالم يطلب عونك، أو تسأله شيئا.
الحرية التي نفتقدها في بلاد التشاكل الجمعي، وفي ثقافة العنف، والجهل والمراقبة التي ننتمي إليها، ثقافة الموت تحت كل الذرائع والمسميات والتي أصبحت تنمو وتتمدد خارج بلادها للأسف لتقضّ مضجع الأبرياء بالخوف، والهاربين بالتشكيك والريب. تعود من السفر وأنت تحمل في داخلك روحا حرة تواقة، منفلتة من كل الأطر والممنوعات، وفقط تحلم أن تمتد إلينا دروس السفر، وثقافة الآخر.
٭ كاتبة عُمانية
نقلا عن القدس